- السميائيات صفة ملازمة للوجود الإنساني
هل السميائيات ضرورية للحياة؟ قد يبدو هذا السؤال بسيطا، لكنه مميز وعملي، ليس فقط بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروسهم في حقل السميائيات، بل إن الآباء المؤسسين[1] لهذا العلم طرحوا السؤال نفسه لما يكتسيه من أهمية قصوى في تناوله ومعالجته لقضايا جوهرية تهتم، عموما، بدراسة الظواهر الثقافية باعتبارها أنساقا تواصلية، تجد سندها المرجعي في السميائيات، ولأن هذا السؤال أيضا، يقودنا إلى طرح أسئلة أخرى من قبيل:
- هل السميائيات صفة ملازمة للوجود الإنساني وخاصّة بكل المظاهر الإنسانية؟
- هل الكائنات الإنسانية، كائنات سميائية بطبعها؟
إذا جعلنا من هذين السؤالين نقطة انطلاقنا، وحاولنا الإجابة عنهما، فإن ذلك لن يقودنا سوى نحو مواقف متطرفة، وهي مواقف يتردّد صداها، في تاريخ البحث السميائي والفلسفي، في المناظرة الشهيرة التي جرت سنة 1984 في جامعة فيكتوريا بطورونطو بين الفيلسوف بول ريكور والسميائي ألجيرداس جوليان غريماص حول «الكليات السردية» فقد عبّر بول ريكور عن موقفه باعتماده وجهة نظر تاريخية محضة، معتبرا السميائيات مبحثا معرفيا بسيطا وحديث العهد مقارنة مع مباحث أخرى. ولم تكن السميائيات بالنسبة إليه ذات يوم، ولأمد بعيد، ضرورة للوجود الإنساني، وهو ما يبرّر، حسب زعمه، عدم جدواها في وقتنا الحاضر. وفي مقابل ذلك ظل غريماص محافظا ومتشبثا بموقفه القائل: إن البنيات السميائية هي بنيات كونية وكلّية؛ وتتبدّى كوْنيتها هذه في التعاطي مع كلّ الظواهر والأنساق الثقافية وصفا وتحليلا. فالتحليل السميائي بالنسبة إليه، قادر على تحديد هذه الكونية والشمولية في الأساطير والحكايات المعبّرة عن كل ثقافات العالم برمّته. ولقد كان غريماص واعيا بمغامرته ومخاطرته في اتجاه تطبيع السميائيات والمعنى؛ أي فقد انحاز نحو موقف يعتبر البنيات المحدَّدَة سميائيا، هي خاصيات من صميم الطبيعة أو من صميم الذهن البشري، وهو ما سيقوده بالتالي، نحو البحث في مجال الميتافيزيقا، حيث قال: «لو لم أكن أخاف اختراق مجال الميتافيزيقا لأمكنني القول إن البنيات السميائية السردية هي من خصائص الذهن البشري»[2].
ولفرادة هذين الموقفين،[3] فإننا مدعوون لتأمّلهما جيدا، لأن ركوب أيّ مغامرة محفوفة بمثل هذه المخاطر، يقتضي التسلّح بالفكر والانخراط في توليفات متّسقة وواضحة. وللتدليل على هذا يمكننا العودة لموقف بول ريكور. لقد اعترف هذا الأخير، من خلال انخراطه في النقاش العام وفي المناظرة بينه وبين زميله غريماص للسميائيات بوظيفتها التفسيرية والتأويلية من خلال عبارة: «التفسير أكثر، يقود نحو فهم أفضل.» وبمعنى آخر ستكون السميائيات ضرورية للتوغّل أكثر فيما نعرفه ونمتلكه، وهذا يبدو سليما وصحيحا بغضّ النظر عمّا إذا كانت السميائيات مبحثا معرفيا مستقلا بذاته أو العكس. لقد كان موقف ريكور سخيا، على الرغم من وضعه السميائيات والسميائيين في أول الأمر في مرتبة ثانوية، قياسا مع ما هو متعارف عليه وما هو شائع بين المفكرين والباحثين. ونودّ الإشارة إلى أنه رغم أهمية وجدوى هذه الفكرة إلاّ أنها ستظل ناقصة، لأننا ندرك مسبقا أن الاشتغال في المنطقة البينية والحدودية بين السميائيات والمعنى الشائع عنها، يمكّننا من إلقاء إضاءات جديدة حول دور السميائيات في الحياة والتداول الاجتماعي للمعنى. فمن خلال هذه العملية يمكننا الوصول أو الإمساك بوجهة نظر أكثر شمولية وأشدّ إدراكا للتعقيدات الثقافية المحيطة بنا.[4]
بناء على هذا، فإنه من الواجب علينا أن نفسّر على نحو أفضل من أجل فهم أكثر. ولتحقيق هذه المهمة الصعبة يلزمنا العودة لبعض نصوص يوري لوتمان وبوريس أوسبنسكي وتأويلها من جديد. ففي مقدمة كتابهما «أبحاث سميائية»،[5] فإنهما يقومان في بعض الفقرات بالربط بين الأبعاد الطبيعية والثقافية والممارسات الصريحة والضمنية والمعرفة اليومية والعلمية.[6] وعلى حدّ قولهما: فإن للسميائيات قيمة جوهرية متأصلة في الوعي الإنساني، وهي من هذه الزاوية ليست ظاهرة قديمة فحسب، بل هي كذلك ظاهرة معروفة. إن الأساسي بالنسبة لهما يتبدّى في كون الإنسان بوعيه البسيط واليومي، لا يَعي السميائيات، بل هو يحتاج لمعرفة علمية تؤهّله ليكتشف سميائياته الخاصة. وإن هذا الموقف، بالنسبة لهما، لا يخلو من مفارقة أو تناقض؛ إذ كيف يمكن للسميائيات أن تكون معروفة ومجهولة في الوقت نفسه؟ إن الحلّ أو على الأقل لتفسير هذا التناقض، هو ما قد يؤدّي بنا إلى فهم أفضل لدور السميائيات في حياتنا. وأفضل طريقة لشرح ذلك هو أن نستعين ونستدعي مفهوم اللعب اللغوي كما وظفه فيلسوف اللغة فيتغينشتاين.[7] إن المعرفة العلمية التي نحتاجها، في كل ما يمكن أن يساعد وعينا وجسدنا على الظهور، ليست بتاتا من نمط المعرفة الذي يثير ردود أفعال والتي لم يفكّر فيها قطُّ لدى عامة الناس، كما هو الحال عندما نكتشف ونفهم نظريات النّسبية ونظريات الجينات أو المورّثات الجينية…، بل هو نمط المعرفة الذي يسعى لاكتشاف طبيعتنا السميائية في أبعادها الجوهرية، وهو نمط يمكن إدراكه عبر ردود أفعال أخرى، نعرفها دائما. وبإمكاننا العثور عن هذا النمط من المعرفة في إطار الإقرار بالحقيقة المعبّر عنها سلفا والتي لا تنتظر سوى من يعترف بها ويعلن عنها. فإذا عدنا إلى سؤال يوري لوتمان وبوريس أوسبنسكي الذي يبدي مفارقة (كيف يمكن للسميائيات أن تكون معروفة ومجهولة في الوقت نفسه؟) ثم إلى سؤالنا الذي شكّل منطلق هذا المبحث (هل السميائيات ضرورية للحياة؟)، فإننا ندرك عبر منطق اللعب اللغوي باستعارتنا لمصطلح فيتغينشتاين والتّمفصلات الممكنة التي تقيمها اللغة في علاقتها بالذات والوجود بأن للسميائيات ضرورة مزدوجة.[8]
- فمن جهة، يمكننا القول مع لوتمان وأوسبنسكي، «إن السميائيات حاضرة دائما وبشكل ضمني في وعي الإنسان وتصرفاته.» وفي هذه الحالة فإنها تحظى بوضع خاص في حياتنا؛ فهي جزء لا يتجزأ منّا ومن وجودنا في حالاتنا وتحولاتنا.
- ومن جهة أخرى، تنتمي السميائيات بوصفها تخصصا معرفيا إلى إبدالٍ (براديغم) عامّ ضمن العلوم الإنسانية في القرن العشرين. فهي تتقاطع مع غيرها من التخصصات في مجال العلوم الإنسانية قصد تفسير ما لم يتم تحليله أو الكشف عن أنواعه السّنَنية من قبلُ، لسبب بسيط، وهو أن السميائيات كانت تتميز «بالبساطة والوضوح والبداهة» على حدّ تعبير يوري لوتمان.[9]
ينطبق هذا تماما على أشياء مثل اللغة والحياة اليومية والثقافة. ومن ثم يبدو واضحا أن وضعا كهذا قد حافظ ولا زال يحافظ أيضا على إمكانية تأسيس علم اللغات. وهو يسعى لفعل ذلك تجنّبا لإبطال الحقيقة العارية التي نعيشها من خلال إنتاج النصوص واللغات واستخدامها دون إعطاء وصف صريح أو رسمي لقواعد عملها. أَلَيْس صحيحا أن نسمي لغتنا الأم «اللغات الطبيعية»، في حين أننا ننسى أو نتناسى بطريقة أو بأخرى اصطناعها القوي والفعال؟ وماذا عن العديد من الأنساق الثقافية المضمرة التي تبنين طرق تفكيرنا وأنماط عيشنا؟
تشكّل السميائيات، من هذا المنظور، جزءا لا يتجزّأ من حركة تاريخية وعلمية ممتدّة. وتتمثل مهمّتها في إظهار وتفسير الآليات والخصائص التي ترتكز عليها حياتنا الثقافية وطرق عيشنا المشترك. إنها تفعل ذلك للكشف عن طبيعتنا الثقافية غير المدركة التي تُصنع بها حركات أجسادنا وإيماءاتنا ومشاعرنا والطريقة التي نرتبط بها مع الآخرين؛ حتى مع أقرب المقربين. لذلك، إذا استطعنا أن نقبل فكرة يوري لوتمان وبوريس أوسبنسكي بصدد تطوير الدرس السّميائي بوصفه نسقا معرفيا شاملا، فإن هذا النّسق سيكون دون جدوى وغير مثمرٍ إنْ هو لم يُستثمر في تعزيز قدراتنا على تحليل قضايانا الثقافية واليومية التي نعيشها من خلال استيعاب أشكال التعبير والمحتوى التي تصوغ حياتنا وتمنح شكلا محققا لذواتنا.
إننا في أمسّ الحاجة للسميائيات باعتبارها معرفة علمية وباعتبارها ممارسة تأويلية لفهم طبيعتنا السميائية في أبعادها الجوهرية في محاولة منّا للإمساك ببعض تلابيب المعنى المنفلِت عبر بنيات وآليات سميائية تنتمي إلينا حتى لو كانت عادةً ما تفلت من قبضتنا. وبالتالي فإننا نعتقد أن الإجابة على السؤال «هل السميائيات ضرورية للحياة؟» يجب أن تكون بـ «نعم، مرتين دائما وأبدا!.»[10]
ولتوضيح هذا بشكل أكثر نقول، إن حاجَة الإنسان للسميائيات تنشأ من ضرورة أساسية، مفادها محاولة العصف بكلّ السّلط (اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو لغوية…) التي تبني وجودها وتستمد شرعيتها من المعاني التقريرية والأحادية، أو تلك التي تؤطِّر ذاتها ضمن دائرة «الواضح والجلي»، فكلّما ابتعدنا عن حالات التعيين والوصف وكلّ ما يدور في فلك المعاني الظاهرة، إلى نظام الفكر والثقافة والرمز كلّما اقتربنا أكثر من حقائق الوجود الإنساني. فعبر الأشكال الرمزية تستطيع الذات الإنسانية الإمساك بكل الممكنات في أبعادها الواقعية أو المتخيّلة؛ «ولأن الفكر الإنساني فكر رمزي فله القدرة على إجراء تمييز بين الواقعي والممكن.»[11] هذا التمييز سيمكنه من امتلاك معارف جديدة، وبفضله يمكن إحداث شروخ داخل كل المتصلات التي تقدِّم نفسها باعتبارها مطلقا. بذلك يكون التأويل تجاوزا للنفعي في الحياة في اتجاه إنتاج ممارسات لا تُدرك إلاّ من خلال استحضار الأشكال الرمزية والثقافية. فالأشكال البدئية المباشرة، تنحو نحو التراجع كلّما تقدّم النشاط الرمزي. وبذلك يمكن القول إن السميائيات في أبعادها الثقافية، يمكن أن يُنظر إليها بوصفها عملية التحرّر التدريجي للذات الإنسانية، «واللغة والأسطورة والدين والفن والعلم هي اللحظات المختلفة لهذه العملية. وفي كل لحظة من هذه اللحظات يكتشف الإنسان سلطة جديدة ويبرهن عليها، إنها سلطة بناء عالمه الخاص.»[12] هذه الأشكال هي التي تُبنين طريقة تفكيره وأفعاله وكينونته؛ إذ الإنسان يصل إلى المخيال والواقعي عبر مصافي الرمزي ولم يكن بوسع هذا الإنسان داخل الرمزي أن يقوم بأيّ شيء أكثر من بناء عالمه الخاص، وهو عالم يجعله قادرا على فهم وإدراك تجربته وتأويلها وتنظيمها وجعلها تجربة كلية. وما ينظّم هذه التجربة في كليتها، هو نفسه ما يعطي ميلادا للدلالة ويحكم مسيراتها، «إن الإنسان لا يعيش في عالم مادّي خالص، بل في عالم رمزي. واللغة والأسطورة والفن والدين هي عناصر من هذا العالم. إنها الخيوط المختلفة والمتنوعة الناظمة لنسيج الرمزية والتجربة الإنسانية. وكل تقدّم في فكر الإنسان وتجربته يقوّي هذا النسيج ويعقّده. ولا يمكن للإنسان، بعد الآن، أن يوجد أمام الحضور المباشر للواقع، ولا يمكن أن يتقابل معه وجها لوجه، لأن الواقع المادّي يتراجع كلّما تقدّم النشاط الرمزي. إن الإنسان، بشكل من الأشكال، يبتعد عن إقامة علاقة مع الأشياء نفسها، ويتقابل مع نفسه على الدوام. إنه مُحاط بأشكال لسانية وصور فنية ورموز أسطورية وطقوس دينية بحيث لا يستطيع رؤية أيّ شيء ولا معرفة أيّ شيء دون تدخّل هذا العنصر الوسيط الاصطناعي، سواء تعلّق الأمر بالممارسة أو التنظير. إن العالم العملي للإنسان (عالم الممارسة) ليس عالم وقائع وأحداث خامّ حيث يعيش وفق رغباته وحاجاته المباشرة، بل إنه يعيش أهواءه وأحلامه وسط الانفعالات الخيالية، إنه يعيشها في الأمل والرّهبة والأوهام والحقائق.»[13] إن هذا الكون الرمزي يجعل الإنسان يبتعد عن المواجهة المباشرة للعالم المادي، حيث يتعذّر إدراكه إلاَّ عبر وساطة الرموز. ومادامت عمليات الإدراك لا تتم بطريقة مباشرة، وإنما بأشكال تأويلية ورمزية، فإن التأويل سوف يستند إلى سنن ثقافية مشتركة تم إنتاجها انطلاقا من أشكال رمزية تختزنها الذاكرة الجماعية، بوصفها تسنينا، وتكثيفا لمجموعة من الممارسات الإنسانية الدالّة؛ «إن علاقتنا بالواقع ليست مباشرة، إننا نكوِّن لأنفسنا نموذجا للواقع عبر تأويل ذي طبيعة رمزية. إن تأويلا من هذا النوع يستند إلى سنن ثقافية مشتركة تشكلت وتطورت داخل السيرورة الإبلاغية. إنها تشتغل كمصافي، وهذه المصافي تسمح لنا بالدخول في علاقة مع الواقعي، والأمر يتعلق بواقع مفكر فيه بشكل مسبق:
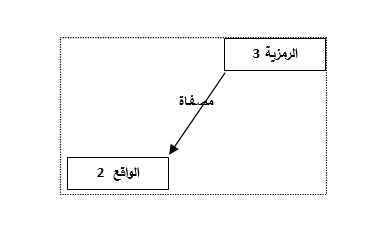
إن علاقتنا بالواقع تتم عبر السنن، فنحن مثلا لا نستطيع التفكير إلا بواسطة اللغة التي تقوم بدورها ببنينة الواقع، وتمدنا بنموذج من هذا الواقع.»[14] وإن الرمز ليس تغليفا عرضيا للفكر، بل هو عنصره الضروري، وتبعا لذلك فكل فكرة دقيقة لا تحد سندها الثابت إلا في الرمزية وفي السميائيات التي تعتمد عليهما. إن الدلالة الرمزية إذن، هي دلالة مركبة، بحيث لا ندرك منها سوى الدلالة الثانوية عن طريق الدلالة الحرفية أو الأولية؛ لذلك تكون الدلالة الثانوية الوسيلة الوحيدة للاقتراب من المعنى المتعدد. إن الرمز من هذه الزاوية يُظهر قصدية مزدوجة؛ قصدية حرفية يتم بموجبها تحديد معنى العلامة كما هو متعارف عليه في أبعاده المباشرة، ولكن انطلاقا من هذه القصدية الأولى يمكن التطلع إلى قصدية ثانوية؛ «وهكذا ففي مقابل العلامات التقنية، الشفافة كليا، والتي لا تقول إلاّ ما ترغب في قوله، فإن العلامات الرمزية تكون كثيفة، هذه الكثافة هي التي تشكل العمق الذاتي للرمز.»[15] فالرمز هو الذي يساهم في تحريك المعنى الأول ويجعلنا ننخرط في صلب المعنى الكامن. وهو يقوم على بنية دلالية محددة، هي بنية التعابير ذات المعنى المزدوج على حد تعبير بول ريكور.
بناء على ذلك، فحاجة الإنسان إلى السميائيات والتأويل السميائي عامة، تبقى ضرورية بوصف السميائيات فعالية دلالية ونشاطا معرفيا وفلسفيا لفهم الحياة واستعادة لمناطق أكثر غورا داخل الذات الإنسانية. وهو نشاط لا يكتفي بالتعيين والإحالة على ما هو معطى بشكل مباشر داخل الواقع، بل يعمل على بناء عوالم دلالية مصدرها التخييلي والرمزي. وهذا وحده كفيل بجعل الذات الإنسانية قادرة على الانفلات من إكراهات اللحظة المباشرة، أي إكراهات”الأنا” و”الآن” و”الهنا”. وتتبدّى ضرورة التأويل السميائي على نحو أكثر، عندما ندرك أن القضايا البديهية التي تشكل عصب حياتنا أصبحت خالية من المعنى والمشروعية. وبمعنى آخر، تصبح هذه الضرورة مُلحّة عندما يعيش الإنسان أزمة سوء فهم تخص ذاته كما تخص الآخر، أزمة يبدو من خلالها المعنى موزّعا بين الماضي والحاضر وبين التقليد والتحديث، بل وحتى مهدّدا بالانقراض من خلال الإفراط في توليده وإنتاجه.
هوامش
[1]– إن الحديث عن العلامة السميائية في تصور بورس، وعن طرق صياغتها وأشكال تداولها هو حديث عن النشاط الإنساني باعتباره بؤرة مركزية منتجة للعلامات ومستهلكة لها في الوقت نفسه. فهذا النشاط لا يقف فقط عند حدود إنتاج موضوعات ثقافية يلقي بها للتداول والاستهلاك، بل إنه يدرجها أيضا ضمن أنساق تعطيها أبعادها وتحققاتها المستقلة. لذلك فالعلامة من حيث الوجود والاشتغال ليست وحدة تهتم بتعيين الأشياء والوقوف عند حدودها فحسب، إنها بالإضافة إلى ذلك تهتم بتأويلها، إذ هي في الأول والأخير نمط في بناء التجربة الإنسانية. من هنا نستطيع القول، إن كل شيء يمكن أن يشتغل بوصفه علامة، فالتجربة الإنسانية تشتغل بكافة أبعادها كمهد للعلامات؛ لحياتها ولنموها ولموتها أيضا. فالإنسان منتج للعلامات وهو أول ضحية لها.
[2]– Franciscu Sedda, Semiotics of Culture(s): Basic Questions and Concepts, in International Handbook of Semiotics Peter Pericles Trifonas Editor, Springer, 2015. P, 676.
[3] – رغم اختلاف المواقف بين غريماص وبول ريكور إلاّ أن العلاقة بينهما ظلت قائمة وصداقتهما كانت دائمة؛ ففي مايو 1985، خلال أمسية تمّ تخصيصها لقراءة كتاب Exigences et Perspectives de la Sémiotique. Recueil d’hommages pour Algirdas Julien Greimas وهي مجموعة دراسات مهداة للسميائي غريماص تكريما له، وفي إطار هذا الاحتفاء ألقى بول ريكور كلمته في حقّه التي ختمها بعبارات ودّ وتقدير قائلا: شكرا السيد غريماص لقد علمتني كيف أقرأ! ويتجلى التعبير عن هذا الامتنان أكثر في مقالات كتبها بول ريكور بعد وفاة غريماص سنة 1992.
Louis PANIER. RICOEUR ET LA SEMIOTIQUE UNE RENCONTRE « IMPROBABLE »? Semiotica, De Gruyter, 2008, 168 (1/4), p. 306.
[4]– Franciscu Sedda, Semiotics of Culture(s): Basic Questions and Concepts, in International Handbook of Semiotics. Op. Cit. P, 676.
[5]-Juri M. Lotman and Boris A. Uspensky. Semiotic Researches, published in Italy in 1973.
[6]– Franciscu Sedda, Semiotics of Culture(s): Basic Questions and Concepts, in International Handbook of Semiotics. Op. Cit. P, 676
[7]– Franciscu Sedda, Semiotics of Culture(s): Basic Questions and Concepts, in International Handbook of Semiotics. Op. Cit. P, 676
[8]– Franciscu Sedda, Semiotics of Culture(s): Basic Questions and Concepts, in International Handbook of Semiotics. Op. Cit. P, 676
[9]-Ibidem.
[10]– Franciscu Sedda, Semiotics of Culture(s): Basic Questions and Concepts, in International Handbook of Semiotics. Op. Cit. P, 677.
[11] – Nicole (Evereat_Desmedt): Le Processus Interprétatif ; Introduction à la Sémiotique. de C.S. Peirce ; Ed ; Mardaga Editeur, 1990 ; p.105
[12] – Ernest Cassirer. Essai sur l’homme. Paris Minuit, 1975, p. 317.
[13] – Ernest Cassirer. Essai sur l’homme. Paris Minuit, 1975, p.p. 43/44.
[14] – نيكول إيفرايرت ـ دسمدت: “الرمزية والمخيال والواقعي”، ترجمة سعيد بنكراد، مجلة علامات العدد 3 السنة الأولى ربيع 1995 ص:70.
[15]–Paul, Ricœur. Le Conflit des interprétations; Ed; Seuil; Paris;1969 Coll‘ L’ordre. Philosophique’; PP: 285/286.
